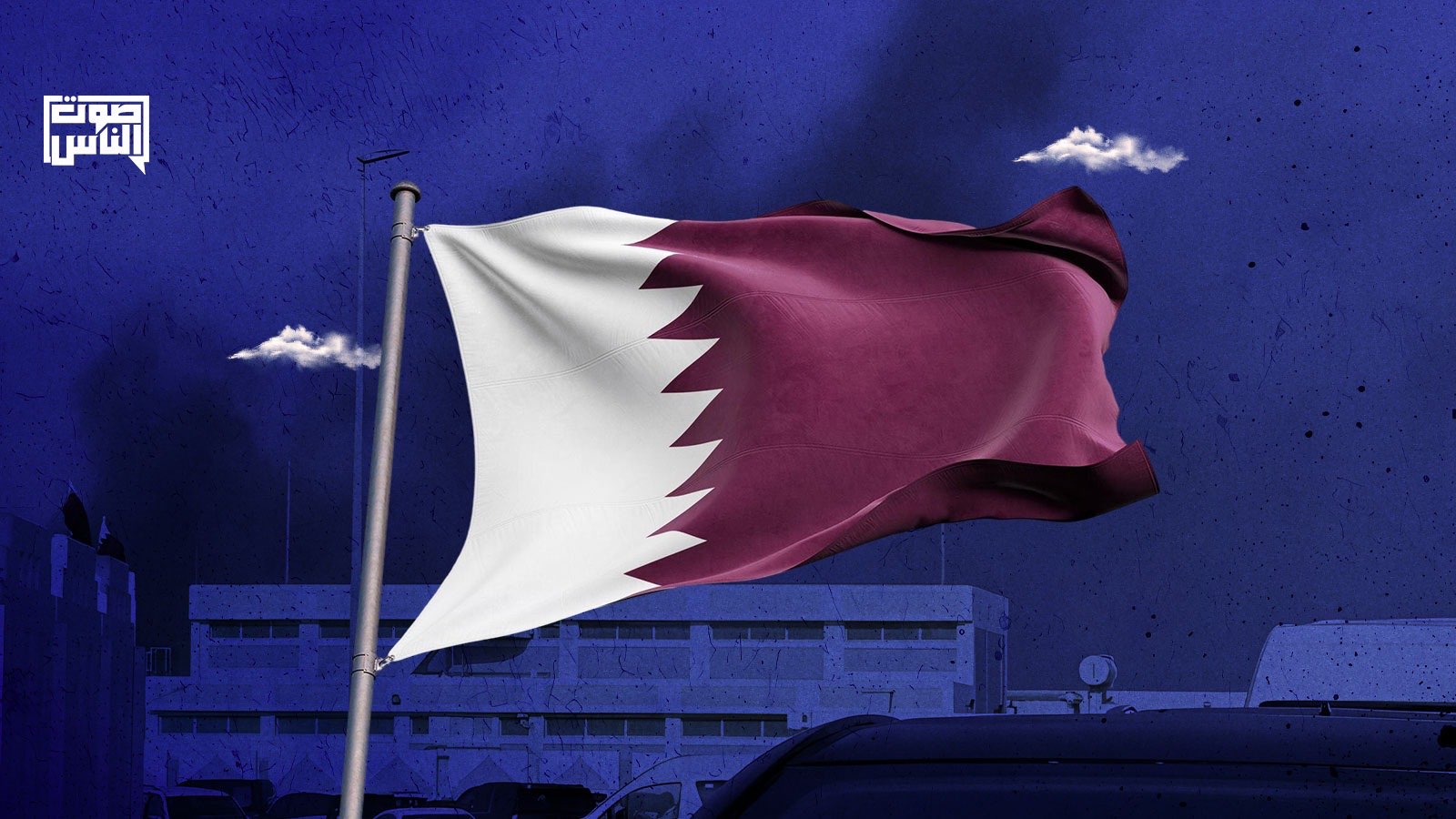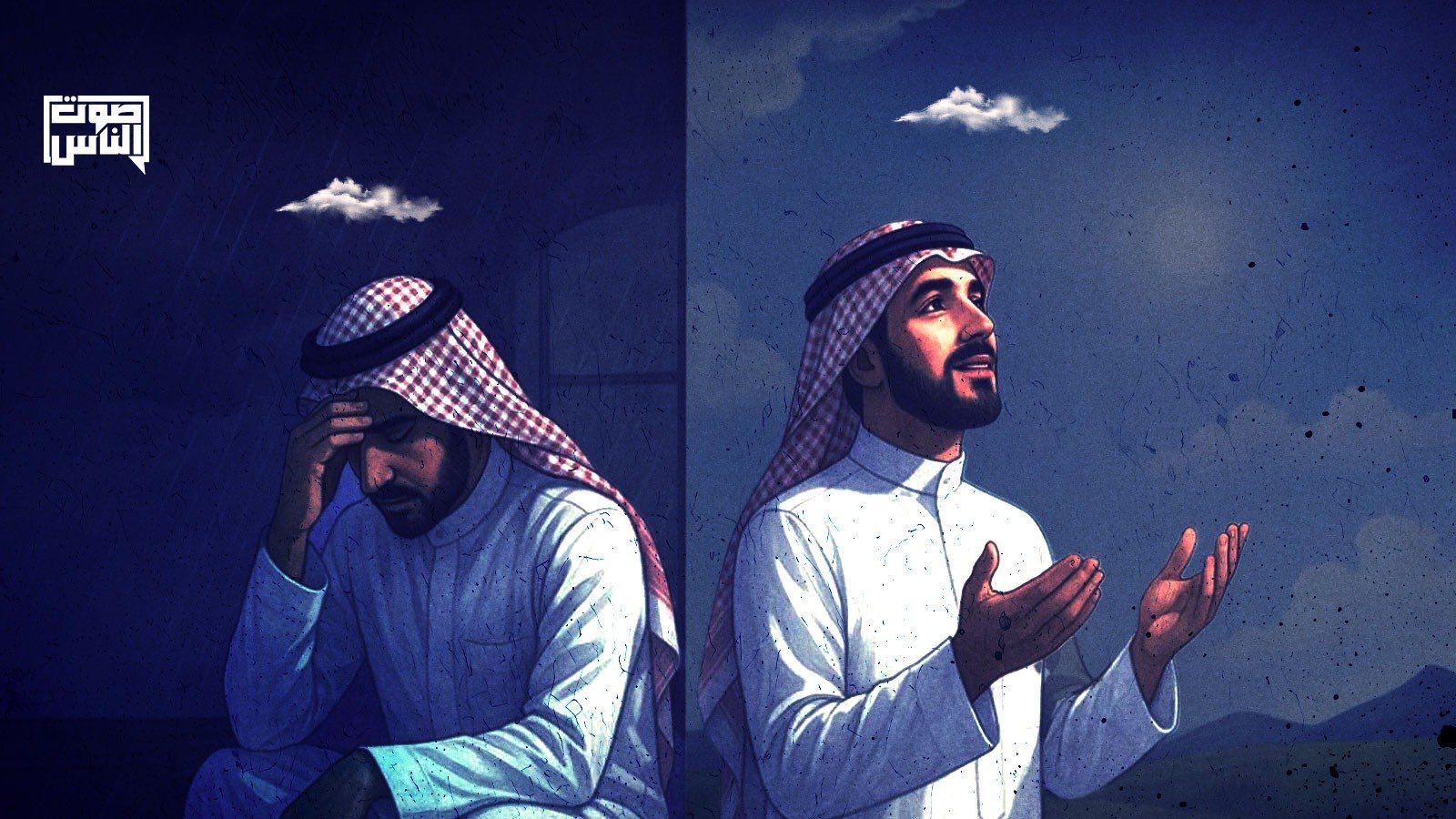مقالات
توطين بلا سيادة: صناعة السلاح في زمن الإرجاء

كيف حوّلت السلطة مشروع الابتكار العسكري إلى استعراض رمزي يعيد إنتاج التبعية ويؤجل لحظة السقوط
وهم التوطين
من يتابع خطاب "رؤية 2030" في شقّه العسكري، قد يتخيّل أنّ المملكة على وشك أن تتحول إلى نسخة خليجية من المجمع الصناعي-الحربي الأمريكي، قادرة على تصميم مقاتلات تضاهي الـF-35 وتصديرها إلى الأسواق العالمية. غير أنّ التدقيق البسيط يكشف أنّ هذا التصوّر لا يعدو أن يكون صورة دعائية أكثر منه واقعًا. فالتوطين الموعود ليس سوى نقل خط إنتاج أجنبي من مصنع في تكساس أو باريس إلى الدمام أو الرياض، بحيث يُعاد تشغيله بأيدٍ محلية، بينما تبقى مفاتيح السرّ وحقوق التصميم محتكرة عند "الشركة الأم". أي أنّنا أمام توطين للآلة لا للفكرة، أمام استنساخ معلب لا يمكن فتحه إلا بمفتاح أمريكي أو فرنسي كلما استدعت الحاجة تعديلًا أو تحديثًا.
تتبدّى المفارقة هنا في صورة مثيرة للسخرية: أشبه بطالب يضع اسمه على مشروع تخرّج جاهز من الإنترنت، ثم ينشر صورته بفخر إلى جوار مجسّم مطبوع ثلاثي الأبعاد، متغافلًا عن أنّ الخوارزمية لم تكن من ابتكاره أصلًا. هذا التناقض لا يكشف فقط عن فجوة معرفية، بل يعرّي مأزقًا بنيويًا أعمق: نظام يَعِد بالابتكار لكنه لا يحتمل شروطه، لأن الابتكار لا يُولد في صالات البروتوكول ولا على منصات المؤتمرات الباذخة، بل في بيئة اجتماعية وسياسية تحتضن النقد والتجريب والفشل. أما السلطة التي ترى في النقد تهديدًا، وفي الفشل عارًا، فلا يمكن أن تُنتج سوى "صناعة شكلية" تُدار بالولاء قبل الكفاءة، وبالخوف قبل الخيال.
من هذا المنظور، يغدو التمييز الجوهري بين الإنتاج والابتكار أكثر إلحاحًا: فالأول لا يتجاوز تشغيل ما صمّمه الآخرون، إدارة خط معقّد، صيانة أداة دقيقة، وضبط إيقاع سلسلة التوريد؛ بينما الثاني هو القدرة على ابتكار الآلة من الأساس، وفق عقيدة قتالية وسيادة معرفية متجذّرة. أن تنتج دبابة أو طائرة مطابقة للمواصفات الممنوحة لك شيء، وأن تمتلك حق تعديل برغي فيها أو تصميمها من الصفر شيء آخر تمامًا. الأول يضعك في موقع التابع المُنفِّذ، والثاني يمنحك حرية صياغة استراتيجيتك بما يلائم واقعك لا واقع الآخرين.
قد يُقال، بطبيعة الحال، إن نقل خطوط الإنتاج خطوة أولى ضرورية. وهذا صحيح من حيث المبدأ، لكنه يظل رهنًا بأن يكون جسرًا نحو الابتكار لا محطة دائمة. فإذا اختُزل "التوطين" في صور مصانع جديدة وأرقام توظيف براقة، تحوّل إلى إعادة إنتاج للعجز في ثوب أكثر لمعانًا. فالمعامل التي تُغطّى بالذهب لا تلد عقلًا مبدعًا إذا كان الفضاء العام مصادِرًا للنقد، وقامعًا للتجريب، وخائفًا من الفشل. وهنا يتحول خطاب التوطين إلى شبيه بالوعود الانتخابية في أنظمة بلا انتخابات: إعلان يُرفع للتصدير الإعلامي، لا للاستثمار في المستقبل.
لكن الفجوة بين الإنتاج والابتكار لا تُردّ إلى البنية السلطوية المباشرة وحدها، وإن كانت هذه الأخيرة هي الشرط الأكثر حضورًا، بل تتجاوزها إلى بنية معرفية وثقافية أوسع. فحين ينظر المجتمع إلى التكنولوجيا بوصفها سلعة تُشترى وتُدار، لا أفقًا يُبتكر ويُنتَج، تصبح كل محاولة للتوطين مجرد إعادة استهلاك للمنقول. الوعي المقيّد بالمنقول، لا المتخيَّل المبدع، هو ما يحدد النتيجة قبل أن يبدأ المصنع عمله. فحتى لو وُفرت أحدث المختبرات، ستظل عاجزة عن إنجاب ابتكار حقيقي ما لم يتحول الوعي إلى وعي نقدي يتعامل مع المجهول كحقل للتجريب لا كخطر ينبغي قمعه.
هنا تتكشف التبعية في أعمق وجوهها: ليست فقط سياسية أو اقتصادية، بل معرفية-رمزية. فحين يبقى "الآخر" الغربي هو مصدر الشرعية التقنية، يغدو سؤال "ماذا ننتج؟" سؤالًا فارغًا، لأن الإجابة دائمًا ستكون "ما يُملى علينا إنتاجه". وبذلك يصبح خطاب التوطين مفارقًا لجوهر السيادة: إذ ينزع إلى التمثيل الرمزي أكثر من نزوعه إلى التحول الجذري. المصانع تتحول إلى مسارح عرض، لا إلى ورش بحث؛ والإنجاز يُقاس بالصور والأرقام، لا بالقدرة على الكسر والاختراع.
وليس من قبيل المصادفة أن يتقاطع هذا البعد المعرفي مع البنية الأمنية للنظام: جيش مزدوج الولاء، انقسام مُمأسس بين المؤسسة النظامية والحرس الوطني، واستعراضات عسكرية لا تخفي هشاشة العقيدة القتالية. بهذا المعنى، يبدو التوطين، في صورته الراهنة، مرتبطًا بمنطق الولاء أكثر من ارتباطه بمنطق السيادة. ولهذا فإن الابتكار سيظل مشروطًا بخلخلة مزدوجة: خلخلة لسلطة سياسية تخشى النقد وتُصادر المغامرة، وخلخلة لثقافة مجتمعية تطمئن إلى استهلاك المنقول وتخشى ارتياد المجهول. من دون هذه الخلخلة المزدوجة، لن يكون "التوطين" سوى طقس احتفالي يتكرر، ووعد مؤجل يتراكم، من غير أن يتحول يومًا إلى مسار تاريخي فعلي.
وعند هذه النقطة، يتضح أن "وهم التوطين" ليس مجرد عجز تقني يمكن تجاوزه بالصفقات أو العقود، بل هو مرآة تكشف حدود البنية السلطوية والمعرفية معًا: سلطة تخشى العقل المستقل، ومجتمع اعتاد أن يرى المستقبل سلعة تُشترى لا أفقًا يُبنى. والسؤال الذي يظل مفتوحًا هنا: كيف يمكن لمن يشتري شرعيته بالصفقات أن يتوهّم أنّه قادر على شراء المستقبل بالطريقة ذاتها؟
من الإنتاج إلى الابتكار : اقتصاد الرخصة ضد اقتصاد التعلّم
أ. فجوة لا تردم بالصمت
حين نعود إلى جوهر خطاب رؤية 2030 في المجال العسكري، نجد أنفسنا أمام كلمة سحرية تتكرّر في كل مؤتمر ومعرض: "التوطين". غير أنّ هذا التوطين الموعود لا يعني، في حقيقته، أكثر من إعادة نصب آلة جاهزة في الداخل بدل الخارج، ليبقى "سر التصميم" محتكرًا في يد الآخر. إنّه أشبه ما يكون بامتلاك فرن بيتزا مستورد كامل، مع دليل استخدام ملوّن، لكن دون معرفة الوصفة السرية للعجين وصلصة الطماطم. النتيجة: إنتاج وافر شكلاً، لكن دون سيادة معرفية.
انطلاقًا من هذا التشبيه، يبرز التمييز الجوهري بين القدرة على الإنتاج والقدرة على الابتكار. الأولى لا تتجاوز حدود تشغيل ما صمّمه الآخرون: إدارة خطّ معقّد، صيانة أداة دقيقة، وضبط إيقاع سلسلة التوريد. أما الثانية، فهي النقلة النوعية التي لا يملكها إلا من يصمم آلته بنفسه، وفق عقيدته القتالية ورؤيته الاستراتيجية، مستندًا إلى قاعدة صلبة من البحث العلمي وملكية فكرية وطنية. إنها، ببساطة، القدرة على أن يُقال: "هذا السلاح يعبّر عن عقيدتي، لا عن شروط الترخيص الموقّعة في باريس أو واشنطن".
ولا يقف الأمر عند حدود المفاضلة النظرية. فالفارق بين الإنتاج والابتكار ليس تمرينًا فلسفيًا عابرًا، بل هو الفجوة الفعلية التي تفصل بين الاستعراضات الفخمة وبين القدرة العسكرية الحقيقية. إذ إنّ القدرة على الإنتاج تعني أن الدولة قد تُخرج من مصانعها دبابة أو طائرة مطابقة للمواصفات الممنوحة لها، لكنها لا تملك تعديل برغي واحد فيها دون إذن الشركة الأم. وحدها القدرة على الابتكار هي ما يمنح الجيش حريته: حرية أن يطوّر سلاحًا جديدًا، أو يعيد كتابة عقيدته القتالية، أو يصوغ استراتيجيته وفق متطلبات واقعه، لا وفق خريطة جاهزة مرسومة في دوائر حلف الناتو.
قد يُقال، بطبيعة الحال، إنّ نقل خطوط الإنتاج، حتى لو كان شكليًا، يظلّ خطوة أولى ضرورية. وهذا صحيح في ظاهره، لكنه مشروط بأن يكون انتقالًا تمهيديًا نحو بيئة تتيح للابتكار أن يتجذّر لاحقًا. أما إذا تحوّل إلى محطة دائمة يُختزل فيها "التوطين" إلى صور لمصانع جديدة وأرقام توظيف مبهجة، فإننا نكون إزاء إعادة إنتاج للعجز المعرفي بوجه أكثر لمعانًا لا أكثر مضمونًا.
ومن هنا تنفتح المعضلة الحقيقية: فالابتكار لا يولد في قاعات البروتوكول ولا على منصات تدشين المصانع، بل في بيئة اجتماعية وسياسية تتسامح مع النقد والتجريب وتحتمل الفشل. أما سلطة ترى في النقد تهديدًا، وفي الفشل عارًا، فلا يمكن لها أن تُنجب عقلًا مبدعًا، حتى لو غطّت معاملها بالذهب. وعند هذه النقطة تحديدًا، يغدو خطاب التوطين شبيهًا بالوعود الانتخابية في أنظمة لا انتخابات فيها: إعلان يُقال للتصدير الإعلامي، لا للاستثمار في المستقبل.
لكن المسألة، في جوهرها، أوسع من البنية السياسية السلطوية. فحتى لو افترضنا قابلية النظام للإصلاح، تظلّ الفجوة بين "الإنتاج" و"الابتكار" ممتدة إلى منظومة معرفية وثقافية تشتبك مع الذات والآخر على نحو أكثر تعقيدًا. فالإنتاج، في صورته الحالية، يقوم على منطق الاستيراد المشروط: استيراد آلة أو براءة اختراع أو حتى
عقلية تشغيل، ثم محاولة تبيئتها ضمن نسيج محلي يُفترض أنه قادر على استيعابها. غير أن هذا الإدماج يظل قاصرًا طالما كانت المخيّلة التقنية نفسها أسيرة للمنقول، لا للمتخيَّل المبدع.
وهنا لا بد من التنبه إلى ما هو أعمق: الوعي، قبل المصنع، هو ما يحدد شكل العلاقة مع التكنولوجيا. فإذا نظرنا إليها بوصفها سلعة تُشترى وتُدار، لا كأفق يُبتكر ويُنتَج من داخل شروطنا، فإن النتيجة ستكون دومًا إعادة استهلاك للجاهز لا خلقًا للجديد. لا يكفي أن نمتلك المعدات، ما لم نمتلك المخيلة التي تدفعها إلى الحافة.
ومن هذه الزاوية تنجلي مفارقة أكثر إيلامًا: فالسلطة قد تضغط من أجل توطين صناعات بعينها، لكن إن لم يتحول الوعي الثقافي نفسه إلى وعي نقدي، قادر على ارتياد المجهول لا الخوف منه، فإن النتيجة ستكون إعادة تدوير قوالب جاهزة داخل مؤسسات براقة. فالمختبر لا يبتكر وحده، بل يبتكر حين يسكنه عقل لا يخشى الفشل. أما في مجتمع يرى في الفشل وصمة، وفي النقد خيانة، فلن يكون المختبر سوى غرفة معقّمة لإعادة التجريب داخل ما هو مرسوم سلفًا.
وبتتبع هذا المسار، يتضح أن التبعية لا تقتصر على الحقلين السياسي والاقتصادي، بل تمتد إلى الحقل المعرفي-الرمزي. إذ حين يظل "الآخر" – غالبًا الغربي – هو المصدر الحصري للشرعية التقنية، تصبح محاولات التوطين مجرد محاولات لإعادة إنتاج ذلك الآخر بأدوات محلية. لا يعود السؤال: "ماذا ننتج؟" بل "كيف نُعيد إنتاج ما أُنتج لنا؟". وهنا تنفصل فكرة التوطين عن معناها السيادي، لتصبح مجرّد تمثيل رمزي يغطي هشاشة البنية.
بناء على ذلك، لا يمكن للابتكار أن يظهر إلا بتحقق خلخلة مزدوجة: خلخلة للبنية السياسية التي تصادر النقد والمجازفة، وخلخلة للبنية الثقافية التي ترتاح إلى الاستهلاك وتخشى الانفلات من السائد. من دون هذه الخلخلة المزدوجة، سيبقى التوطين مشروعًا مؤجلًا، محكومًا بأن يتحوّل إلى طقس احتفالي متكرر لا إلى مسار تاريخي فعلي.
ب. مقارنة سعودية–تركية–إيرانية: بين «توطين الآلة» و«سيادة الفكرة»
حين نجعل الفارق بين القدرة على الإنتاج والقدرة على الابتكار عدسة تحليل، لا يعود الحديث عن التوطين تكرارًا بيروقراطيًا، بل يصبح مسألة سيادة معرفية واستقلال استراتيجي. ومن هذه الزاوية، تبرز ثلاث حالات مغايرة: نموذج سعودي يراهن على توطين الآلة بوصفه سياسة وصورة، نموذج تركي يسعى نحو سيادة الفكرة عبر منظومة مؤسسية تدمج الابتكار بالتكرار والقتال والتصدير، ونموذج إيراني يُبدع بالضرورة، محكومًا بمنطق العزلة والهندسة العكسية وتكثير الأدوات الرخيصة والفعّالة. فما الذي يكشفه هذا التباين عمليًا؟
عند النظر إلى الدافع المؤسِّس للابتكار، يتضح أن ما يدفع الآلة ليس دائمًا الرغبة، بل الحاجة أو الخوف. في الحالة الإيرانية، تمثل العقوبات والحصار المتن لا الهامش؛ إذ حين تُغلق الأبواب الخارجية، لا مفر من اختراع نوافذ محلية: صواريخ، مسيّرات، ومنطق "الكثرة الرخيصة" كبديل عن التفوق النوعي. في تركيا، لم يكن هناك حصار شامل بل تجارب حرمان تراكمي دفعت نحو مشروع معلن للاستقلال الدفاعي التدريجي، تُبنى لأجله مؤسسات وجامعات وسوق تصدير تتعلم بالبيع والخسارة. أما السعودية، فدافعها المعلن اقتصادي–صوري (تنويع، نسب توطين، معارض)، ودافعها الضمني أمني–نظامي: إدارة الولاءات وضبط البنى العسكرية. في مثل هذا السياق، يتحوّل التوطين إلى خطاب إدارة، لا مشروع سيادة.
من هنا يُفهم أن موضع السيادة في دورة السلاح لا يُقاس بمكان تشغيل الآلة بل بمن يملك مفاتيح تعديلها. تركيا راكمت، بمرور الوقت، سيادة تصميمية في مجالات محددة: المسيّرات، الأنظمة الإلكترونية، أجزاء من المدرعات؛ مع استمرار فجواتها الكبرى (المحركات الثقيلة مثلاً). إيران، عبر التراكم العكسي، امتلكت سيادة مرتفعة في بعض المجالات (الصواريخ، المسيّرات) رغم استمرار عجزها في المقاتلات والمنظومات المعقدة. السعودية، في المقابل، لا تزال في موقع التابع: خطوط تجميع، ملكية فكرية أجنبية، ومصانع مشروطة تُنتج دون حق في التعديل أو التطوير. توطين هنا لا يتجاوز جلد الآلة، أما عظامها فلا تزال مستعارة.
هذا الوضع يعكس طبيعة بنية السلطة والجيش بوصفها "معمل سياسة". في إيران، الحرس الثوري ليس مجرد جيش بل عقل ابتكاري مسيّس، يملك اقتصاده ومختبراته، ويوجه أولوياته نحو الردع غير المتناظر. الانقسام المؤسساتي هناك لا يعيق الابتكار، بل يمنحه غاية. تركيا، من جهتها، صاغت مجمعًا صناعيًا–بحثيًا بقيادة الدولة، تتغذى منه شركات خاصة، وجامعات، وتجارب ميدانية حقيقية. السعودية، على الضد، تحافظ على بنية مزدوجة: جيش/حرس، ولاءات متقاطعة، وعقيدة قتال داخلية، يُفرّغ فيها المصنع من محتواه ليخدم الخطاب أكثر من قدرته على إحداث تحوّل فعلي. لذا تتفوّق لغة الصورة على منطق التجربة.
وحين نصل إلى طبيعة الاقتصاد التقني، يتبدّى الفارق أكثر: الابتكار التركي مبني على "سلسلة ابتكار": تمويل موجه، عقود طويلة المدى، ربط أكاديمي، وسوق تصدير يعيد تغذية المنظومة. الابتكار الإيراني فطري–ميداني: لا
سوق مفتوحة، ولا تمويل مؤسسي، لكنّ الميدان يعلّم، ويُعدّل، ويُنتج. السعودية، في المقابل، أسست "سلسلة ترخيص": اتفاقيات نقل تقنية، مراكز صيانة، تدريب على التشغيل، لا على التصميم. المال موجود، لكن الحرية غائبة؛ وحين يُدار البحث بالولاء، تصبح المختبرات ديكورًا، لا منجم ابتكار.
وبالقياس إلى التعلم القتالي والتسويق الخارجي، نجد تجربتين تمضي فيهما الحرب والمعرفة جنبًا إلى جنب. إيران تختبر منتجاتها في ساحات وكلاء: المسيّرات، الصواريخ، أسلحة الردع، كلها تُقاس فاعليتها في مسارح واقعية. تركيا تختبر وتصدّر، وتعود من السوق بخبرة تُحسّن المنتج وتولّد طلبًا جديدًا. السعودية، رغم حربها الطويلة في اليمن، لم تحوّلها إلى مدرسة ابتكار: بقيت خبرة الاستهلاك أعلى من خبرة التصنيع، والنتائج محفوظة في ملفات المورد، لا في عقول المهندسين.
أما معادلة الكلفة والوفرة مقابل التعقيد والندرة، فتكشف اختلاف الفلسفة. إيران اعتمدت "الكثرة الرخيصة": ما يمكن تعويضه بسرعة أهم مما يمكن تبخّره في لحظة. تركيا تمزج بين التكلفة المتوسطة والطموح العالي، فتنتج سلّمًا تقنيًا قابلًا للصعود. السعودية، بدأت من القمة: صفقات ضخمة، معدات معقدة، ثم محاولة لإنزال التصنيع إلى القاعدة، لكنها وقعت في فجوة الرخصة، وغياب مورّدين محليين. النتيجة: هرم مقلوب، ثقيل، تقفُه الصور وتثقله الشروط.
ويُختتم المشهد مع زمن الابتكار: بين الوعد والتراكم. تركيا راكمت: مشاريع تتدرّج، نسخ تتطور، إخفاقات تُعلَن وتُعالَج. إيران تراكمت بالإكراه، لكنّها راكمت. السعودية، في المقابل، تدير الزمن عبر خطاب الطموح: تواريخ تُعدَّل، أهداف تُحدَّث، وتوطين مؤجل يتحوّل إلى سياسة في حد ذاته. الزمن هنا لا يُستثمر، بل يُسوَّق.
في المحصّلة، لا بد من خلاصة معيارية صريحة لا تجميل فيها:
السيادة على السلاح: مرتفعة انتقائيًا في إيران، صاعدة أفقيًا في تركيا، متدنية في السعودية.
عمق الابتكار: تركي مؤسسي–قابل للتعلّم، إيراني تكيفي–وظيفي، سعودي ترخيصي–صوري.
علاقة السياسة بالمعرفة: في إيران، الابتكار وظيفة بقاء؛ في تركيا، وظيفة مكانة؛ في السعودية، خطر بنيوي.
فما الذي يعنيه هذا للسعودية؟
لا يكفي أن تُعد النسب وتُعقد الصفقات. ما تحتاجه السعودية عبور حقيقي للفجوة: خلخلة مزدوجة تطال بنية السلطة والمعرفة معًا — تحرر البحث من شبهة التهديد، وتعيد تعريف الفشل كضرورة تعلم، لا كوصمة. مؤسسة
تَربط التمويل بعقود تطوير، وتُنبت سلسلة موردين يخسرون ويربحون دون أن تُعاق مصالحهم. من دون هذا، تبقى المقارنة فادحة: تركيا تُصدّر ما جرّبته، إيران تُنتج ما يضمن بقاءها، السعودية تدشّن ما يُصوّر ويُعلّق على الجدار.
وفي الخاتمة، الفارق ليس في حجم المال، بل في حقّ التصرّف بالبرغي: أن تملك القرار دون استئذان. إيران انتزعته في بعض المجالات لأنها حوصرت؛ تركيا بنته لأنها أنشأت مؤسسات تربط السوق بالمعرفة؛ السعودية لم تنله بعد، لأنها جعلت من "التوطين" اسمًا حركيًا لشراء آلة بجلد محلي. والابتكار، في حقيقته، لا يُشترى. بل يُصنع على درجات: تصميم، اختبار، فشل، تعديل، تصدير، فدورة جديدة. ومن لا يملك حقّ التجريب، سيبقى واقفًا تحت صورته، لا أمام تاريخه.
ج. ثقافة الفشل: من العار إلى كلفة التعلّم
لا ابتكار من دون وعي نقديّ يعيد تعريف الفشل، لا بوصفه عارًا، بل كلفةً ضرورية لدرس لا يُنسى. وهذه، على وجه التحديد، الثقافة التي يبدو المخيال السعودي المعاصر أبعد ما يكون عنها. ففي المشهد العام—بأبواقه الإعلامية وذبابه الإلكتروني—ينشغل الخطاب لا بتقصّي دروس الفشل الذاتي، بل بالابتهاج بفشل الآخرين، كما لو كان تعثّر الخصم استراتيجية دفاع وطنية. غير أن الأمر يتجاوز الشماتة العابرة، ليغدو إنكارًا ممنهجًا لفاعلية خصومنا، بلغة ساخرة تصادر حقهم في الاعتراف، وتسقط في الوقت ذاته فرصتنا في التعلّم.
يمكن الإمساك بهذه الدينامية عبر مثال دالّ: توصيف تسليح الخصوم، وبالأخص صواريخ الحوثيين. فحين يُصرّ الخطاب الإعلامي الموالي على تسميتها «مقذوفات»—حتى وهي فرط-صوتية، دقيقة، وفاعلة في ضرب أهداف استراتيجية داخل العمق السعودي—يصبح التحقير وسيلة دفاع رمزيّ تُعطّل الاستجابة العملية. ذلك أن السخرية لا تُرمّم منشأة، ولا تردع تهديدًا؛ بل تُخدّر الحسّ الاستراتيجي وتعطّل دورة التعلّم: فإذا كان السلاح «تافهًا»، فما الحاجة لتطوير دفاعاتنا؟ وإذا كانت إصاباته «عرضية»، فما ضرورة تعديل عقيدتنا القتالية؟
في هذا السياق، يغدو معيار الابتكار العسكري واضحًا: النجاعة، لا الفخامة. والنجاعة لا تُقاس بعدد المصابيح في حفل التدشين، بل بزمن التطوير، وكلفة كل طلقة، وكثافة النيران لكل ريال، وبساطة سلسلة التوريد، وقابلية
التعويض السريع. ما فعله الخصم—ولو من موقع اقتصادي هش—كان تحويل القيود إلى ميزات: دقة كافية، وفرة عددية، كلفة زهيدة، وسهولة نشر. وفي المقابل، وفرة المال السعودي لم تُنتج سيادة، بل ازدواجًا: شراء دون تصميم، وإنكارٌ يجرّ إنكارًا.
ما يلزم إذًا ليس مزيدًا من التحقير الرمزي، بل تواضعٌ معرفي يعترف بفاعلية نجاحات الخصم—مهما بدت متواضعة—بالكبرياء نفسها التي نطالب بها الآخرين في الاعتراف بإنجازاتنا. هذا التواضع هو ما يفتح الطريق للانتقال من "اقتصاد الرخصة" إلى "اقتصاد التعلّم": فرق اختبار تفشل سريعًا لتُعدّل سريعًا؛ معايير أداء تربط التطوير بالحقل لا بالمنصّة؛ سلاسل مورّدين محليين يختبرون حظهم في الربح والخسارة؛ وعقود تسليح مشروطة بنتائج ميدانية، لا بلقطات كاميرا.
فاللغة، في نهاية المطاف، ليست قشرة فوقية، بل جهاز مفاهيمي كامل. وحين يُعاد تعريف الفشل ككلفة تدريب لا كعار مجتمعي، تتحول «المقذوفات» من نكتة إلى سؤال جادّ: كم تكلف؟ كم تخترق؟ ما الذي يمنحها هذه الفاعلية؟ وكيف نُقلّد نقاط تفوقها بسلاسل محلية، وننزع عنها تفوقها بترقيات دفاعية حقيقية؟ عندها فقط تُصبح السخرية فائضًا لا نحتاجه، ويغدو الخصم—بصرف النظر عن موقعه في المخيال الوطني—مختبرًا مجانيًا يُعلّمنا من حيث لا يريد.
الخلاصة لا تحتاج تورية: من يسخر طويلًا من «مقذوف» الخصم، قد يستيقظ على صفّارة إنذار في قلب منشآته. ومن يضحك على فشل الآخرين بدلًا من أن يتعلّم من نجاحاتهم الجزئية، يحكم على نفسه بالبقاء تلميذًا دائمًا في مدرسة يموّلها ولا يتخرّج منها. إعادة تعريف الفشل ليست تمرينًا نفسيًا، بل شرطٌ صناعيّ وسياديّ لا غنى عنه للانتقال من "توطين الآلة" إلى "سيادة الفكرة".
البنية الأمنية والازدواجية العسكرية: جيش الولاء لا جيش الوطن
حين يُوضع خطاب "التوطين" تحت المجهر الأمني، يتضح أنه لا يتعلّق فقط بمصانع تُفتتح أو صفقات تُعلن، بل يمسّ البنية العميقة للمؤسسة العسكرية السعودية. فالمشكلة ليست في حجم التسليح، بل في كيف يُدار هذا التسليح ولمَن يُوجَّه. فمنذ عقود، تأسّست البنية العسكرية السعودية على قاعدة مزدوجة: جيش نظامي ضخم العتاد والتسليح، يُقابله حرس وطني ذو ولاء مباشر للعائلة المالكة. ولم تكن هذه الازدواجية خللًا عارضًا، بل استراتيجية مقصودة لضمان أمن السلطة، لا أمن الدولة.
في هذا السياق، يصبح أي حديث عن "توطين الصناعات الدفاعية" مفصولًا عن الواقع ما لم يُربَط بالبنية الأمنية التي تحكمه. فحتى لو أنتجت المصانع مقاتلات متطورة أو دبابات حديثة، تظل العقيدة الأمنية قائمة على أولوية الداخل، لا تهديدات الخارج. الجيش، من حيث الشكل، يتبع وزارات ومؤسسات؛ لكن من حيث الوظيفة، يبقى مفكك الولاء، منقسمًا بين مهام السيادة ومهام الضبط. وهذا ما يجعل الولاء أولوية تسبق الكفاءة، والسيطرة أهم من الابتكار.
من هنا يتضح التناقض الجذري: النظام قادر على شراء التكنولوجيا، لكنّه عاجز عن شراء عقيدة وطنية قتالية. فجيش وُلد ليحرس العرش لا يستطيع أن يتحول تلقائيًا إلى جيش يحمي الأمة. وإذا ما اقترب من هذا الدور، يتحول إلى تهديد للنظام نفسه. ولهذا لا يُستغرب أن تتحوّل الاستعراضات العسكرية إلى أدوات تمويه على هذا الفراغ البنيوي: مناورات تُبث على الشاشات، طائرات تُحلّق في السماء، أعلام تُرفع وصور تُلتقط، فيما العقيدة القتالية تظل محصورة في الداخل. في لحظات السلم، تبدو الدولة في أبهى صورها: صفقات، أرقام، معارض.
لكن عند المواجهة الفعلية، تتكشف هشاشة البنية، ويتضح أن الانقسام المصمم لحماية النظام شلّ قدرته على حماية الدولة.
غير أن هذا الانقسام لا يبقى حبيس النخب العسكرية أو المجالس المغلقة، بل يتسرّب إلى الوعي الجمعي، مشكّلًا صورة مزدوجة عن الجيش. فمن جهة، يُقدَّم كرمز للوطنية والسيادة في الخطاب الرسمي، ومن جهة أخرى، يُختبر على الأرض كأداة ضبط داخلي. هذا التناقض يخلق علاقة ملتبسة: المواطن يُحب الجندي كرمز، ويخشى حضوره كأداة قمع. الجندي نفسه يتحرّك داخل هذا الانشطار: هو حارس للوطن في الصورة، ورقيب على الداخل في الوظيفة.
وتترتب على هذا الانشطار نتائج رمزية عميقة: إذ يغدو الظهور العسكري احتفالًا، لا ممارسة سيادية. في المخيال الشعبي، يظهر الجيش حين تُقام الاستعراضات، لا حين تُحمى الحدود. يغيب عن الجبهات، ويحضر في النشرات. وهذا "تفريغ المعنى" لا يُضعف صورة الجيش فقط، بل يُعيد تشكيل مفهوم "الوطن" نفسه. فحين يُربط الجيش بالوطن في الخطاب، بينما يُسخَّر لحماية السلطة في الواقع، تتحوّل الوطنية إلى أداة رمزية، ويُختزل "الولاء" في الخضوع للنظام، لا للكيان الجمعي.
وفي هذه البنية، يصبح التطبيع مع التبعية أمرًا يوميًا. فإذا كان الجيش نفسه لا يمتلك استقلال قراره، ولا يُسمَح له أن يكون موحَّدًا، فكيف يمكن للمجتمع أن يتخيّل سيادة معرفية أو ابتكارًا عسكريًا مستقلًا؟ إنّ "الولاء"، حين يُحوَّل إلى قيمة عليا مطلقة، يُعيد تشكيل المخيال الجمعي، بحيث يُعاد تعريف كل مفاهيم الوطنية على قاعدة الطاعة. لا يعود المواطن يرى فرقًا بين حماية الوطن وخدمة السلطة؛ فالمفردتان تندمجان في خطاب شمولي لا يعترف بالفصل بين الدولة والنظام.
لكنّ هذه الإستراتيجية ليست اعتباطية. إنها إنتاج لغوي وسياسي ممنهج. في خطاب ولي العهد أمام مجلس الشورى، يُقدَّم ارتفاع نسبة التوطين من 2% إلى 19% كإنجاز سيادي، لكنه يظل رقمًا معزولًا عن سؤال جوهري: من يملك التصميم؟ من يتحكم في الكود؟ وكذلك، عبارة "التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين" تُضفي شرعية على التبعية التقنية، فتُقدَّم كأداة تسريع، بينما هي في الواقع صمام تحكُّم خارجي. وحتى العبارات الكبرى مثل "رفع القدرات الدفاعية إلى أعلى المستويات العالمية"، تُخلق لتضخيم الانطباع بالقوة، بينما تُبقي العقيدة القتالية مرتهنة لاحتياجات السلطة، لا لمتطلبات الأمة.
بهذا التلاعب الرمزي، تنجح السلطة في خلق مفارقة لغوية–سياسية فريدة: فهي تتحدث عن الوطن والهوية، لكنّها تعيد تعريف كليهما بما يتناسب مع حدود بقائها. تصبح الوطنية اسمًا حركيًا للولاء، ويغدو أي نقد لهذا التلازم أشبه بالخيانة. وهكذا يفقد المواطن قدرته على التمييز: الدفاع عن الوطن يُختزل في الدفاع عن النظام، والاختلاف مع السلطة يُقدَّم كتهديد للسيادة.
ولذلك، فإن الاستعراضات العسكرية لا تهدف إلى إظهار القوة تجاه الخارج، بل إلى إعادة تثبيت هذا النظام الرمزي في وعي الداخل. حين يُقال "الوطن فوق الجميع" في عرض عسكري، يُفهم ضمنًا أن "النظام فوق الجميع". وحين يُرفع شعار "السيادة لا تُساوَم"، يُقصَد به السيادة على المجتمع، لا السيادة في الجغرافيا. وهنا يتحقق أخطر أنواع الإخضاع: ليس عبر القمع المباشر، بل عبر التطبيع المعرفي. فتصبح الوطنية طاعة، والولاء إلغاء للذات، والسيادة مشهدًا لا ممارسة.
والنتيجة أنّ المخيال العام يُعاد تشكيله على نحو يجعل البدائل نفسها غير قابلة للتصوّر. لا جيش موحّد بلا انقسام، لا سيادة بلا رخصة، لا وطنية بلا إذعان. وفي هذا الأفق، يُقفل القاموس على نفسه، وتُمنع الكلمات من إنتاج المعنى، فيصبح التفكير في جيش وطني مستقلّ، لا مجرد مخاطرة، بل مستحيل لغوي: فكرة لا مكان لها في اللغة التي صاغها النظام.
الهدف الأسمى للسلطة: إرجاء السقوط لا بناء المستقبل
قد يبدو، لأول وهلة، أن فشل النظام السعودي في بلوغ هدفه المعلن—أي "توطين 50%" من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030—ليس سوى خيبة استراتيجية تُسجَّل عليه من الخارج. لكن التدقيق في بنية هذا "الفشل" يكشف أنه ليس عارضًا، بل جزء عضوي من منطق السلطة نفسها، بلغة سردية قبل أن يكون بلغة مؤشرات. فالسلطة لا تصوغ الأهداف بوصفها التزامات للتحقق، بل كاستراتيجيات لإنتاج الاستمرار؛ لا يُراد من الأهداف أن تُنجَز، بل أن تُبقي النظام في موقع الفاعل، ولو من داخل دائرة المراوحة.
بهذا المعنى، لا يفشل النظام فقط لأنه لم ينجز، بل لأنه يعجز حتى عن أن يخدم نفسه بكفاءة. يريد جيشًا حديثًا، فيُعيقه انقسام الولاءات بين جيش نظامي وحرس خاص؛ يريد توطينًا صناعيًا، فيعلق في بيروقراطية الصفقات المعلّبة؛ يريد بيئة بحث، لكنه يخنق الحريات التي تسمح بابتكار حقيقي. كل مصنع جديد إذًا لا يُمثّل نقطة انطلاق بل محاولة ترقيع؛ كل نسبة معلنة لا تُقاس بما تحقّق بل بما لم يُنجَز. يتراكم الإنجاز شكليًا، لا كتحول، بل كاستدراك دائم على فشل مقيم.
وبالتالي، فإن النجاح الوحيد المضمون هو البقاء؛ لا بقاء المشروع، بل بقاء السلطة ذاتها. لكنها حتى في هذا البقاء تمارس نجاحًا هشًّا، أقرب إلى طلاء الشقوق من ترميم الجدار. فكلما أخفقت خطة، جرى استبدالها بأخرى لا لتُحقّق، بل لتُؤجَّل. فيصبح الفشل شرطًا للاستمرار، لا قطيعة معه؛ سلطة تعيد إنتاج فشلها كي تستمر، حتى يُصبح الزمن نفسه عبئًا لا يمكن تجاوزه.
وحين ننتقل إلى المستوى الرمزي–الخطابي، يتضح أن "الوعد المؤجل" ليس نتيجة عارضة، بل تقنية سلطوية بامتياز. فإطلاق هدف مثل "50% توطين" لا يُقصد به تحقيق النسبة، بل استدعاء أفق زمني مفتوح يُبقي المجتمع في حالة ترقّب دائم. يصبح الانتظار فعل ولاء، والتأجيل ممارسة طقسية تُعبّر عن حيوية النظام لا عن تحقّقه.
في هذا النمط من إدارة الزمن، تُبنى "الشرعية" على الطريق لا على الوصول؛ الإنجاز لا يعني تحقق الاستقلال أو الابتكار، بل مجرد وجود خطة قيد التنفيذ. هكذا يُعاد تعريف الفشل كمرحلة، لا كتعطيل: لم نبلغ النسبة؟ لأننا بصدد بلوغ نسبة أكبر. تعثّر المشروع؟ دليل على مرونته. تعطّلت الخطة؟ برهان على قابليتها للتعديل. كل نقص يُعاد تأويله كعلامة على الحيوية، وكل فشل كإشارة على الصيرورة.
ويُستثمر هذا المنطق في كل مفاصل الخطاب الرسمي: المعارض، الاستعراضات، المؤتمرات، وكل الأرقام التي تُعلن بوصفها إنجازًا، بينما لا تُقدَّم آليات قياس أو مساءلة. "الحركة" تُباع كتحقّق، و"الانتظار" يُسوَّق كأفق. وما يُسمّى بـ"الاستراتيجية" لا يُعاش إلا بوصفه وعودًا دائمة، تتحرك زمنياً لكنها لا تتقدّم معرفيًا.
غير أن هذا الإفراط في استعمال الوعد ينتج، في جوهره، فراغًا رمزيًا. المواطن يفقد القدرة على قياس الزمن السياسي بمعايير واقعية؛ يتحوّل المستقبل إلى ملكية لغوية للنظام، لا إلى أفق جماعي يُصاغ من تحت. وهكذا، يُختزل الحاضر إلى استعراض، ويُسطّر الماضي كأسطورة مؤسسة، بينما يُحتكَر المستقبل في خطاب لا يَعد بالتحقّق، بل يَطلب الانتظار.
بهذه الطريقة، تتحول "الشرعية" إلى علاقة إدمان متبادل: النظام يُجدّد وعوده كي يبقى في المخيال، والمجتمع، بعد طول انتظار، يعتاد على استقبال الوعود لا محاسبتها. ومع كل دورة تأجيل، يتعذّر التفكير في بديل. وكأنّ المشروع لم يُصمَّم ليُنجَز، بل ليُبقي الجميع في حالة استعداد زائف.
وإذا وسّعنا الزاوية، لا تعود هذه التقنية حكرًا على السعودية، بل جزءًا من هندسة سلطوية عربية عامة. من مصر إلى الجزائر، من الخليج إلى السودان، تتكرّر اللعبة: "رؤى استراتيجية"، "خطط تنموية"، "نهضة قادمة"، تُصاغ لا لتُنجَز، بل لتُؤجَّل. الأمل نفسه يُحوَّل إلى أداة ضبط: من لا ينتظر، يُصنَّف كعدمي؛ من يطلب تقييمًا، يُتهم بالتشكيك.
في هذا السياق، يغدو الخطاب التنموي امتدادًا للخطاب الأمني: كلاهما لا يُنجز، بل يُدير الإرجاء. فلا استقرار دون صبر، ولا مشاركة دون إذن، ولا نقد إلا بإطار مرسوم. حتى صور "السيادة" و"التنوع" و"الجيش القوي" تتحول إلى رموز تُكرر دون تحقق، أيقونات في الشوارع، شعارات في المؤتمرات، دون أفق ملموس للتحقق الجماعي.
وهنا تقع المفارقة الأعظم: السلطة، وهي تُغرق الحاضر في الاستعراض، تُمسك بالمستقبل كأداة ضبط. وكلما طالت دورة الوعد، تعذّر على المجتمع استعادة زمنه. لم يعد يُنتج مستقبله، بل يُستهلَك به. ولا يعود للزمن معنى إلا بوصفه مادة سلطوية تُوزّع كما يُوزّع الريع. الحاضر خشبة، الماضي أسطورة، والمستقبل شعار.
وعلى مستوى فلسفة الزمن السياسي، تنكشف الصورة الأوضح: الديمقراطية، بوصفها إمكانًا جماعيًا، هي فتح الزمن أمام الناس لصياغة مستقبلهم؛ أما السلطوية، فهي إغلاق هذا الزمن في دائرة خطابية لا تُنتج إلا التكرار. إنها لا تعيش داخل التاريخ، بل تُعيد تشكيل الزمن بوصفه مادة للسيطرة: كل شيء يتحرك، لكن لا شيء يتغيّر.
استدامة الفشل
ما يكشفه تحليل خطاب "رؤية 2030" في بُعده العسكري لا ينحصر في فجوة تقنية بين إنتاج وابتكار، ولا يتوقف عند التناقض الأمني بين "جيش الولاء" و"جيش الوطن"، بل يمتد ليطال منطق السلطة نفسه، بما هو آلية لإدارة الزمن، لا لصياغة مشروع. حتى حين تُقاس السلطة بمعاييرها الداخلية، يبقى الفشل هو القاعدة، لا الاستثناء: أهداف تُعلن ثم تُعدَّل، وعود تُطلق ثم تُمدَّد، ومشاريع تُدشّن ثم تُغطّى باستعراض جديد. ليس هذا الفشل حُكمًا خارجيًا، بل تجربة داخلية تُعيد السلطة عبرها إنتاج ذاتها: ماكينة تعيش على تأجيل الغد لا على تحقيقه. فالمعيار الوحيد الذي تُنجِز السلطة وفقه هو البقاء ليوم إضافي، لكنّها تفشل حتى في تحقيق الوعود التي صاغتها لخدمة هذا البقاء. تريد "توطين 50%"، فتغرق في صفقات بلا سيادة؛ تريد "جيشًا حديثًا"، فتُعيد إنتاج ازدواجية الولاء؛ تطمح إلى "تنمية عسكرية"، لكنها تخنق كل شرط معرفي لإمكان الابتكار. الإنجاز، حين يوجد، يبقى محصورًا في منطق التدارك: ترقيع، لا قطيعة؛ استدراك، لا انبثاق؛ تعاطٍ مع أعراض الفشل، لا جذوره.
ومن هذا المنظور، فإن "نجاح" النظام في تأجيل السقوط لا يُعدّ نجاحًا فعليًا، بل إرجاءًا يفضح عجزًا بنيويًا مستمرًا. كل إنجاز يتحول بسرعة إلى عبء رمزي: المصنع واجهة بلا سيادة، العرض العسكري ستار للانقسام، النسبة المعلنة رقمٌ يُذكّر بالعجز لا بالتقدّم. في الجوهر، نحن أمام سلطة تملك المال والآلة، لكنها تفتقر للقدرة الذهنية على تحويل هذا المال إلى معرفة، وهذه العتاد إلى استراتيجية. ولذلك فهي لا تمارس الإرجاء من موقع القوة، بل من موقع العجز عن تخيّل بديل.
لكن الفشل هنا لا يظل حبيس القطاع العسكري، بل يتسرّب إلى الزمن السياسي كلّه. السلطة لا تُخفق فقط في بناء جيش أو مصنع، بل تعجز عن تأسيس زمن مختلف، قابل للتحقّق. المستقبل يُختزَل في خطاب، الحاضر يُستنزف في الاستعراض، والماضي يُستدعى كأسطورة لتثبيت سردية الشرعية. وهكذا يتحوّل الفشل من حدث إلى بنية، من عثرة إلى أسلوب حكم: وعود تتكرر، أهداف تتبدّل، وشرعية تُصاغ على صورة غدٍ لا يأتي. بهذه الطريقة، يصبح الفشل قابلًا للاستدامة. لا كعارض يُمكن تجاوزه، بل كشرط ضروري لإعادة إنتاج السلطة. سلطة تنجح في أن تفشل باستمرار: تُخفق في تحقيق وعودها، تُخفق في خلق بيئة تسمح بتحقيقها، وتُخفق في الخروج من بنية الفشل ذاتها. ما يُسمّى "نجاحًا" ليس أكثر من مهارة في إدارة الإرجاء، لكن حتى هذه المهارة تتآكل بمرور الزمن، إذ لا يمكن تأجيل السقوط إلى ما لا نهاية. وعند نقطة معينة، يغدو الإرجاء ذاته مستحيلًا. ينكشف الزمن المؤجل، وتتفكك الواجهة، وتتعرّى الحقيقة: أن "الشرعية" المبنية على إعادة إنتاج الفشل لم تكن
سوى عبور معلّق فوق هاوية. وحين يحين وقت الحساب، لا يبقى من خطاب المستقبل إلا صدى الوعود، ولا من الشرعية إلا تاريخ من التأجيلات التي ذابت لحظة احتكاكها بالواقع.
ليس "التوطين" في الحالة السعودية مجرد مشروع صناعي متعثر، ولا هو إخفاق تقني قابل للتجاوز بعقد جديد أو مصنع آخر، بل هو تمظهر لبنية أشمل تُعيد إنتاج نفسها عبر أزماتها، وتُحوّل الفشل من عارض إلى نظام. فالسلطة، إذ تعجز عن بلوغ أهدافها التقنية–العسكرية، لا تُواجه هذا العجز بمراجعة جذرية، بل تُعيد تصريفه عبر خطاب استعراضي–أمني يُفرغ المفاهيم من مضامينها: "الابتكار" يصبح تشغيل خط إنتاج مرخّص، "السيادة" تعني تنسيقًا مع الشريك الأجنبي، و"الوطن" يُختزل في صورة النظام نفسه.
تتقاطع هنا المستويات كافة: التقنية، التي تعجز عن تجاوز اقتصاد الرخصة؛ الأمنية، التي تُكبّل العقيدة القتالية داخل منطق الضبط؛ الرمزية، التي تستبدل الفعل بالعرض؛ والزمنية، التي تُحوّل المستقبل إلى وعد دائم التأجيل. في هذا الكلّ المركّب، لا يبدو الفشل انحرافًا عن المسار، بل المسار ذاته. يُعاد إنتاجه بأدوات حديثة، ويُسوّق بلغة السيادة، ويُطبع في الوعي بوصفه قدرًا لا مفر منه. وحين يُصبح "التوطين" اسمًا حركيًا لتثبيت التبعية، و"الابتكار" مرادفًا للاستيراد، و"الجيش" أداة ضبط لا حماية، فإنّ المعضلة لا تعود مسألة تقنية أو ظرفية، بل بنيوية. نحن بإزاء سلطة لا تسعى لبناء المستقبل، بل لإرجاء لحظة الانهيار؛ لا تحتكر الموارد فقط، بل تحتكر الزمن، وتُحوّل الحاضر إلى استعراض، والماضي إلى أسطورة، والمستقبل إلى خطاب لا يُتحقّق.
في هذا الأفق، يصبح الفكر النقدي ضرورة لا ترفًا: لا لمجرد تشخيص الأعطاب، بل لتفكيك النظام الرمزي الذي يُحوّل الإخفاق إلى إنجاز، والإرجاء إلى استراتيجية، والشرعية إلى صورة مُعلّقة. إنّ كسر دائرة "توطين الآلة" لا يبدأ من عقد تصنيع، بل من مساءلة من يحتكر الحق في الحلم، ومن يقرّر ما يُصنَّع، وما يُقال، ومتى يبدأ الزمن.