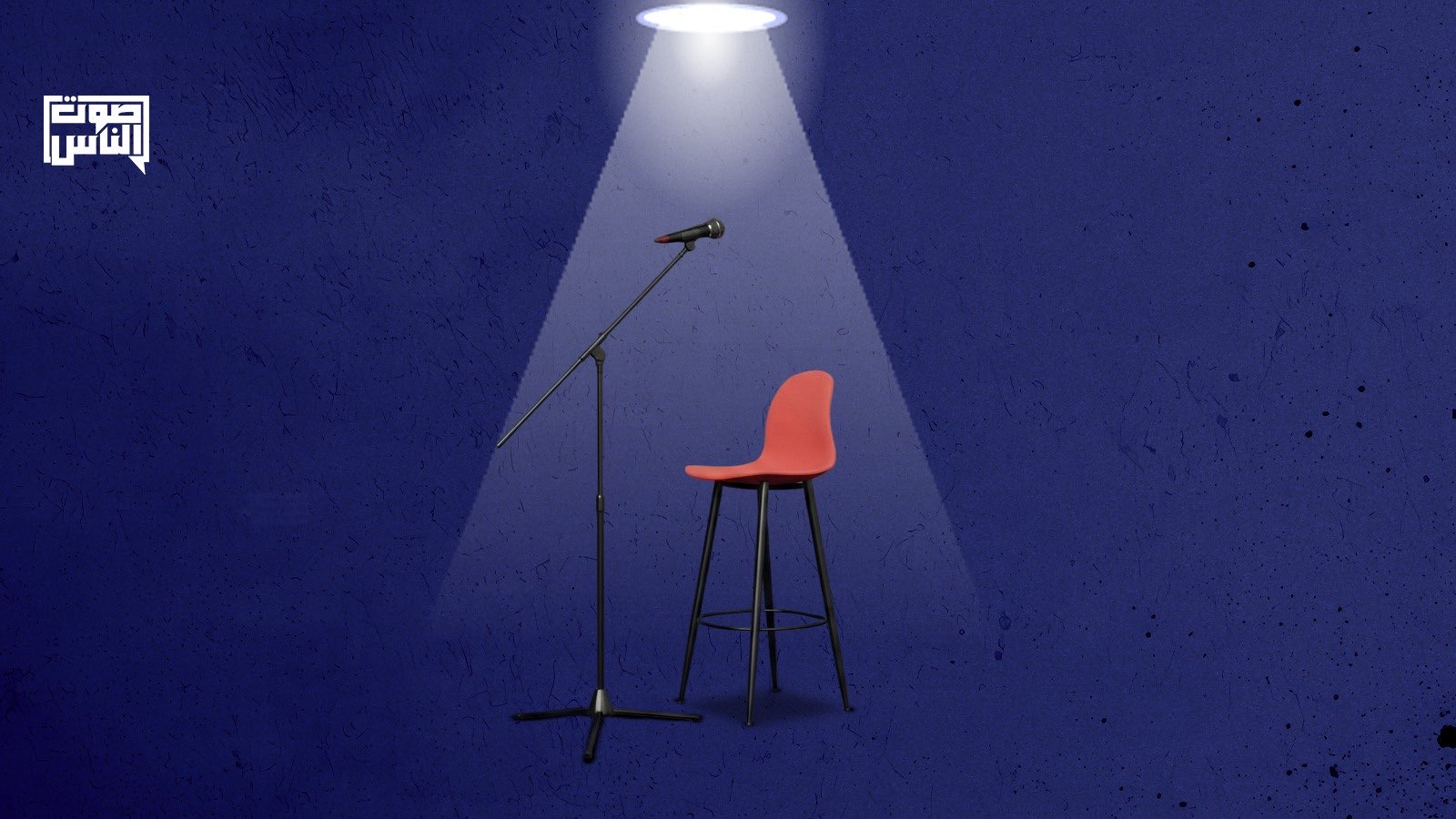مقالات
إمبراطورية الدولار: حين يدفع العالم فاتورة الهروب الأميركي

وهل إسرائيل إلا وجه آخر لهذا النموذج؟
بعد الحرب العالمية الثانية، خرجت الولايات المتحدة باعتبارها القوة الوحيدة القادرة على إعادة تشكيل النظام العالمي وفق شروطها. لم يكن تدخلها في الحرب إلا في مرحلتها الأخيرة، لكنه كان كافيًا لتضع يدها على مفاصل القرار المالي والسياسي. وفي عام 1944، وقبل حتى أن تنتهي الحرب فعليًا، جاء اتفاق "بريتن وودز" ليؤسس نظامًا نقديًا عالميًا جديدًا، يجعل من الدولار عملة مركزية مرتبطة بالذهب، بينما ترتبط باقي العملات به. أما الجنيه الإسترليني، رمز السيادة البريطانية، فكان في طريقه للانكفاء، ومعه نفوذ الإمبراطورية العجوز.
هذا الربط بين الدولار والذهب منح الولايات المتحدة سلطة مزدوجة: سلطة طباعة النقد وسلطة ضبط السوق العالمية وفقًا لمصالحها. غير أن هذه السلطة لم تصمد طويلًا. ففي عام 1971، وتحت ضغط الطلب العالمي المتزايد على الدولار، أعلن الرئيس ريتشارد نيكسون فكّ الارتباط بين الدولار والذهب فيما عُرف بـ"صدمة نيكسون". لم تعد أمريكا قادرة – أو راغبة – في تغطية عملتها، فقررت ببساطة أن الثقة بها تكفي. ومنذ ذلك الحين، لم يعد الدولار مغطى إلا بوهم القوة الأمريكية، لا بذهب العالم.
هذا التحول أنتج موجات تضخمية ضربت الداخل الأمريكي. وللهروب من هذا المأزق، بدأت أمريكا بإعادة هيكلة بنيتها الإنتاجية. لم تعد ترى التصنيع على أراضيها ضرورة، بل وجدت ضالتها في نقل خطوط الإنتاج إلى بلدان منخفضة الكلفة، حيث الأيدي العاملة رخيصة، والرقابة أضعف. لم يكن هذا إصلاحًا اقتصاديًا، بل شكلًا من أشكال الهروب إلى الأمام، تفاديًا لانفجار داخلي كان يلوح في الأفق.
لكن كلفة هذا الهروب لم تدفعها أمريكا وحدها. لقد أُلقيَ بالعبء على الكوكب بأكمله. صدّرت أمريكا أزمتها للعالم: التضخم، الديون، الفوضى النقدية. ثم، لتبرير استمرارية النظام، طرحت شعار "الأسواق الحرة" وروّجت له كأمر أخلاقي وعقلاني، بينما كانت تستخدمه أداة لإحكام قبضتها على اقتصادات العالم. منظمة التجارة العالمية كانت ذراعًا لهذا التمدد، لا آلية للعدالة الاقتصادية.
في كل مرة تُقدم فيها أمريكا على إعادة ترتيب علاقاتها، يكون الثمن من خارجها: إغلاق المصانع في الجنوب، تدمير العملات، تفكيك الاقتصادات، وترسيخ أنظمة تابعة لا تملك إلا التكيف مع متطلبات الرأسمال الأمريكي العابر للحدود. العولمة، بهذا المعنى، لم تكن إلا إعادة إنتاج للهيمنة بثوب قانوني وواجهة كونية.
العلاقات التي بنتها أمريكا مع العالم، منذ نشأة هذا النظام، لم تكن علاقات متوازنة. كانت دومًا غير متكافئة، قائمة على التبعية والوصاية لا على الندية أو المشاركة. لقد تعمّدت الولايات المتحدة ألا تُنتج شركاء، بل تُبقي الجميع في حالة احتياج دائم لها. تدعمهم لتسيطر، تُغدق لتُذل، تعين لتبتز. إنها "علاقة إعالة مشروطة": تقدم وتمنّ، تمنح وتُحقّر، ثم تلومهم على اعتمادهم عليها.
من هنا نفهم أن الحديث عن "تغيير" في علاقات أمريكا، كأن تستبدل شريكًا بآخر، ليس دقيقًا. فهي لا تنظر إلى الآخرين كشركاء أصلًا، بل كأدوات في ترتيب جديد، كلما اهتز النظام. وعليه، حين يُلمّح ترامب إلى تودده لروسيا أو تقاربه معها، فهو لا يسعى لبناء علاقة جديدة، بل لتفكيك علاقة قائمة بين موسكو وبكين. إنه لا يتحالف، بل يُراوغ، ويضرب الأطراف ببعضها ليبقى في المركز.
وهذا السلوك في السياسة الخارجية يعكس وجهًا أكثر جذرية وخطورة: نزعة لاستبقاء السيطرة بأي ثمن، حتى لو كان الثمن هو تفكيك البنى الدولية نفسها. ترامب لا يُخفي رغبته في تحطيم كل ما لا يُبقي أمريكا في موقع السيادة. وحتى خصومه في الداخل لا يختلفون كثيرًا، وإن لبسوا وجوهًا دبلوماسية.
وهنا نصل إلى صورة موازية: إسرائيل.
الدولة الصهيونية، بممارساتها الاستعمارية، تمثل نموذجًا متقدمًا من الاستيطان القائم على الإبادة والتطهير العرقي. لكنها لا تُشبه أمريكا فقط، بل تُعيد إنتاج منطقها ذاته. فهي لا تمارس فقط استعمار الأرض، بل استعمار الرواية، وتسويق وجودها كـ"ضرورة" لا كعدوان. تمامًا كما فعلت أمريكا مع الأرض والسكان الأصليين، تفعل إسرائيل مع الفلسطينيين.
السؤال الذي يطرح نفسه: هل إسرائيل نموذج مستقل؟ أم أنها امتداد عضوي للمنظومة الأمريكية؟
هل هي مجرد دولة في الشرق، أم أنها صورة مُصغّرة من أمريكا نفسها، تنفّذ ما لا تجرؤ أمريكا على تنفيذه مباشرًة؟
وهنا، لا بد من إعادة النظر في طريقة مقاربتنا للصهيونية. فهي لا تمثل اليهودية، بل تُقوّضها. الصهيونية مشروع قومي عدواني، لا ديني. بل إنها خطر على اليهود أنفسهم، لأنها نزعت عنهم بعدها الروحي، وجرّدت مرجعيتهم الدينية من بعدها الأخلاقي، واستبدلتها بمنطق القوة والاستيطان.
ليس من الإنصاف إذن تحميل اليهود كجماعة بشرية أو دينية وزر كيان عنصري لا يعبر عنهم، بل يُسيء إليهم، ويشوّه تراثهم.
وإذا كانت أمريكا قدّمت نفسها نموذجًا لهذا الشكل من السيطرة، فإن إسرائيل لم تكن سوى "الفرع الوظيفي" الذي تأمرك تمامًا في بنيته وأخلاقه.